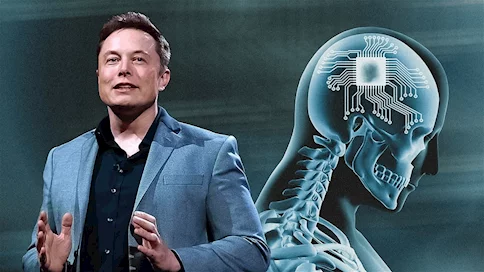رحلة عبر حواسنا: كيف تحكي الروائح قصتنا؟
رحلة عبر حواسنا: كيف تحكي الروائح قصتنا؟
تُعدّ الرائحة حاسة قوية تُشكّل جزءًا لا يتجزأ من تجربتنا الإنسانية. فهي لا تُسهم فقط في تمييز النكهات، بل تُثير ذكريات الماضي بشكل قوي، وتُؤثر على مشاعرنا، وربما حتى على صحتنا. وقد تكون الأمل في تشخيص الألزهايمر باكراً.
تُعدّ الرائحة حاسة قوية تُشكّل جزءًا لا يتجزأ من تجربتنا الإنسانية. فهي لا تُسهم فقط في تمييز النكهات، بل تُثير ذكريات الماضي بشكل قوي، وتُؤثر على مشاعرنا، وربما حتى على صحتنا. وقد تكون الأمل في تشخيص الألزهايمر باكراً.
ماذا يمكنك أن تفعل مع أنفك؟
في عام 1935، أجرى عالم النفس «دونالد ليرد» دراسة رائدة تُسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الرائحة والذاكرة. فقد لاحظ أنّ عدداً من العلماء كانوا يُركزون على حاسة البصر، ويُهملون حاسة الشم، على الرغم من أهميتها في عالم الحيوان.
جادل «ليرد»، وهو أستاذ في جامعة كولجيت الأميركية، بأنّ حاسّة الشم قد تمّ تجاهلها من دون مبرّر. فكتب: «حتّى علماء النفس المعاصرين لدينا، يمرّون عرضاً بحاسّة الشم، بإعتبارها حاسة طاغية بين الحيوانات ولكنها ناقصة عند البشر».
وقد توصل «ليرد» وزملاؤه إلى نتائج مذهلة، حيث إستطاعت الروائح أن تُعيد إلى الأذهان ذكريات قوية وعاطفية، بدءًا من رائحة العطر التي تُعيد إلى الذهن حفل رقص غريب، إلى رائحة الصوف التي تُذكرنا بمعطف أحد الأقرباء المفقودين.
لقد كشف علم الأعصاب عن الآليات التي تُمكن الروائح من إثارة الذكريات. فقد أظهرت الدراسات أنّ الروائح تَنتقل من الأنف إلى البصلة الشمية، ثمّ إلى مناطق مختلفة من الدماغ تُشارك في التعلّم والعاطفة والذاكرة، مثل اللوزة الدماغية والحصين.
ويُمكن للرائحة أن تُثير ردود فعل عاطفية قوية، لأنّها ترتبط بشكل وثيق بالذاكرة. فإذا كانت الرائحة مرتبطة بلحظة عاطفية معينة، فإنّها تُمكّن من إسترجاع تلك اللحظة بشكل واضح، حتى بعد مرور عقود من الزمن.
بعد مرور ما يقرب من قرن من الزمان، يحرز العلماء خطوات كبيرة في فهم العلاقة التي إستشعرها «ليرد» ، بل وحتّى تسخيرها لتحسين الصحّة. يقول «سانديب روبرت داتا»، أستاذ علم النفس «من الواضح الآن أنّه على الرغم من أنّ حاسّة الشم لدينا ليست قويّة مثل حاسّة الشم لدى الفأر أو كلب الصيد، إلّا أنّها مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمراكزنا المعرفيّة والعاطفيّة ومراكز ذاكرتنا.»
كيف تثير الروائح الذكريات؟
يقول «داتا» ، لقد كشف علم الأعصاب عن آليات عمل الحواس عند الحيوانات للتفاعل مع العالم من حولها، والكامنة وراء قدرة الرائحة على تحفيز الذاكرة.
وهي ذات أصول تطوّريّة. إعتمد أسلافنا القدماء على الرائحة لبناء خرائط لمحيطهم وتذكّر الأماكن التي مروا فيها. وأنّه «يمكنك التفكير في الدماغ الأصلي باعتباره حاسّة الشم بالإضافة إلى حاسّة التنقّل وحاسّة الذاكرة».وهذا ما يفسّر سبب إرتباط كل هذه الهياكل بشكل وثيق، ولماذا تكون ذكريات الرائحة مثيرة للغاية. هذه الروابط لا تزال قائمة في علم وظائف الأعضاء لدينا. يحتوي الأنف البشري تلك الجزيئات وترتبط بمستقبلاتها المطابقة. يقول «داتا» «إنّ الأمر يشبه إدخال مفتاح في القفل» حيث تقوم خلايا الدماغ التي تسمّى الخلايا العصبيّة الحسيّة الشمية بإطلاق إشارات كهربائيّة على طول المحاور العصبيّة إلى أجزاء مختلفة من الدماغ.
بعد وصول إشارات الرائحة إلى البصلة الشمية، تُعالج بسرعة قبل أن تُرسَل إلى مناطق رئيسية في الدماغ:
القشرة الشمية: تُحدّد خصائص الرائحة وتُعرّفها.
اللّوزة الدماغيّة: تُعالج العواطف المرتبطة بالرائحة.
الحصين: يُخزّن الذكريات المرتبطة بالرائحة.
إذا إعتبر الحصين أنّ الرائحة مهمّة، وخصوصًا إذا كانت مرتبطة بلحظة عاطفية معينة، فيُمكنه حفظ هذه المعلومات وتخزينها إلى أجل غير مسمّى.
وتُشير الدراسات إلى أنّ نظام حاسّة الشم «تطوّر بشكل أساسي لتوصيل المعلومات إلى مراكز الذاكرة والعاطفة هذه»
بمعنى آخر، تُرسَل إشارات الرائحة مباشرةً إلى هذه المناطق الدماغية، بينما تمرّ المعلومات الحسية الأخرى (مثل المشاهد والأصوات) عبر المهاد أولاً، المسؤول عن نقل المعلومات الحسيّة وتنظيمها،والتحكّم في النوم والإستيقاظ والعواطف.
هذا الترابط الوثيق بين حاسة الشم ومراكز الذاكرة والعاطفة يُمكن أن يُفسر لماذا تُعدّ ذكريات الرائحة غالبًا أكثر عاطفيّة وأكثر إرتباطًا بالطفولة من الذكريات التي تُثيرها الحواس الأخرى.
حاسة الشم وصحة الإنسان: علاقة وثيقة
لا عجب أن يستغلّ صانعو العطور وشركات الشموع قوة الرائحة لتنشيط الذاكرة، فالأمر يتجاوز مجرد الإستمتاع بعبقٍ جميل. تُشير الأبحاث العلمية إلى أنّ للرائحة تأثيرًا عميقًا على الصحة الجسدية والنفسية.
تقول الدكتورة راشيل هيرز، عالمة الأعصاب في جامعة براون، إنّ «الرائحة قادرة على إثارة إستجابة عاطفية فورية إلى جانب الذاكرة، وحالاتنا العاطفية تؤثر بشكل كبير على صحتنا الجسدية». تُؤكد الدكتورة هيرز على أهمية الدراسات التي تربط بين إسترجاع الذكريات عبر الرائحة وتحسين المزاج وتقليل التوتر.
تُظهر الأبحاث أنّ الروائح التي تَستحضر ذكريات شخصية تُحفّز على التنفّس بشكل أعمق وأبطأ مقارنةً بالروائح اللطيفة والعامة. كما لفتت الدراسات إلى أنّ الذكريات المُستحثة بالرائحة تُقلّل بشكل ملحوظ من علامات الإلتهاب في الجسم.
تُفسّر هذه النتائج المفيدة لماذا يمكن أن يؤدي فقدان حاسة الشم إلى ضرر في الصحة النفسية. يُوضح داتا: «عندما نُحرم من حاسة الشم، نشعر بالضياع والإرتباك بشأن مكاننا بطريقة لم نتوقعها». تُذكّرنا حاسة الشم باستمرار بالمكان الذي كنا فيه وأين وصلنا.
أداة قوية لفهم الدماغ وعلاج الصدمة
لا تُثير جميع الروائح مشاعر الراحة والتركيز التي يصفها «داتا». فالتطوّر قد أثّر على العلاقة بين الرائحة والذاكرة، مما يجعل الرائحة لا تُخبرنا فقط بما هو جيد، بل تُنبهنا أيضًا لما هو سيء
يقول كيري ريسلر،أستاذ الطب النفسي ورئيس قسم الأبحاث في مستشفى ماكلين الأميركية:
«إذا ارتبطت رائحة ما متعلقة بصدمة تعرّض لها شخص ما، فمن المؤكد أنّها ستكون من أقوى مسبّبات الصدمة التي يعاني منها». يمكن أن تظهر روائح غير متوقعة دون سابق إنذار، وتؤدي بسرعة إلى إسترجاع شديد لنوبة إضطراب ما بعد الصدمة.
إنجذب ريسلر، الذي درست أبحاثه البيولوجيا العصبية للخوف والقلق عند الفئران، إلى دراسة الرائحة بسبب الفرص المثيرة التي تُقدمها. إذ يرتبط كل مستقبل شمّي في أنف الثدييات بجين معين، ويمكن للعلماء التحكّم فيه لتغيير كيفية إدراك الدماغ للروائح، بل وحتى لجعل الدماغ يُكوّن ذكريات رائحة وهمية. تسمح هذه الروابط المباشرة للباحثين بدراسة كيفية إستجابة الدماغ للبيئة، بما في ذلك التجارب المؤلمة، وكيف يمكن عكس هذه الإستجابات في الدماغ أثناء التعافي من الصدمة.
في إحدى الدراسات، أدخل ريسلر وزملاؤه روائح محددة إلى الفئران مع محفزات سلبية مثل صدمة صغيرة في القدم. أظهر سلوك الفئران أنّها تطورت ليس فقط خوفًا أو نفورًا من هذه الروائح فقط، بل أيضًا المزيد من الخلايا العصبية في الأنف المرتبطة بشكل خاص بتلك الروائح، بالإضافة إلى كبيبات أكبر، وهي مجموعات من الخلايا العصبية التي تنقل الإشارات من جزيئات الرائحة إلى الدماغ.
أراد ريسلر وزملاؤه فهم ما إذا كان من الممكن عكس هذه المخاوف من خلال الإنقراض، وهي طريقة للعلاج بالتعرّض لصدمة، تُقدم فيها الرائحة المرتبطة بذاكرة سلبية بشكل منهجي دون تعرّض سلبي. بدا الأمر ناجحًا، حيث قال ريسلر: «يشير هذا إلى أنّ الجهاز الشمّي عبارة عن نظام مرن يتكيف مع البيئة التي يعيش فيها الحيوان، ليتمكن من الإحتفاظ بذكريات الرائحة في حالة ذات أهمية بيئية ما»
ويقول ريسلر إنّ هناك حاجة لدراسات أكبر حول العلاج بالتعرّض للرائحة، ويوضح أنّه يمكن أيضًا تدريب المرضى على تطوير «ذكريات أمان» حول رائحة معينة، مثل رائحة الخزامى، والتي يمكن استخدامها لتهدئة مشاعر القلق أو ذكريات الماضي عند ظهورها.
الرائحة المفقودة: أمل جديد في مكافحة ألزهايمر؟
تُعتبر الرائحة بوابةً سحريةً إلى عالم الذكريات، فهي قادرة على إحياء مشاعر وأحداث قد طواها النسيان. يقول الباحثون إنّ الرائحة، كما وصفها «ليرد»، هي «طريقٌ إلى العقل»
تُثير بعض الروائح تساؤلاتٍ مثيرةً حول قدرتها على إستعادة ذكرياتٍ دفينةٍ في أعماق أدمغتنا، ذكرياتٍ قد لا نتذكرها إلا عند إستنشاق تلك الرائحة مجدداً. فهل يمكن أن تكون ندرة بعض الروائح، تلك التي نشمها مرة واحدة فقط، هي السبب في وجود ذكرياتٍ مدفونةٍ في أذهاننا؟
وتُثير الرائحة أيضاً آمالاً جديدةً في مجال علاج فقدان الذاكرة، فهل يمكن إستخدامها لتحفيز الذكريات المفقودة لدى المصابين بالخرف ومرض الزهايمر؟ رغم أنّ مفهوم «العلاج بالذكريات» باستخدام الرائحة جديد نسبياً ولم يتمّ إختباره بشكلٍ كاملٍ، إلّا أنّه يُستخدم بالفعل في بعض المستشفيات ومرافق الرعاية.
من الغريب أنّ الأبحاث تُشير أيضاً إلى أنّ فقدان الشمّ قد يكون أحد الأعراض الأولى لمرض الزهايمر. فقد وجد «مارك ألبرز» وزملاؤه في مستشفى ماساتشوستس أنّ انخفاض قدرة الإنسان على التعرف على الروائح قد يسبق تطور المرض بعدة سنوات، مما يفتح الباب أمام إستخدام اختبار الرائحة لتحديد الأشخاص المعرضين للخطر.
يُؤكد «داتا» على أهمية هذا الإكتشاف، قائلاً: «من غير الواضح سبب حساسية الجهاز الشمي للغاية لعملية المرض التي تسبب مرض الزهايمر، لكن من المؤكد أنّ هناك إرتباطاً وثيقاً بين الرائحة والذاكرة».
ويُضيف «داتا»: «نحن جميعاً مهتمون بذكرياتنا وتراجعها مع تقدمنا في العمر، ونأمل أن نتمكن من إستخدام ذاكرة الشمّ لمعرفة المزيد حول ما يحدث أثناء أمراض مثل الزهايمر».
ويُوضح أنّ التفاعلات بين القشرة الشمية والحُصين يمكن أن تكون بمثابة نموذج للعمليات التي يستخدمها الدماغ عند محاولة تذكر أشياء أخرى غير الروائح، فالدوائر الداعمة للرائحة مشابهة جداً من الناحية المعمارية للدوائر المشاركة في الذاكرة.
ويُختتم «داتا» حديثه بالقول: «إنّ التفكير في الذاكرة الشمية كنموذج للذاكرة بشكل عام أمر مفيد حقّاً».
المصدر: مولي ماكدونو ، المحرر المساعد لمجلة الطب في جامعة هارفارد