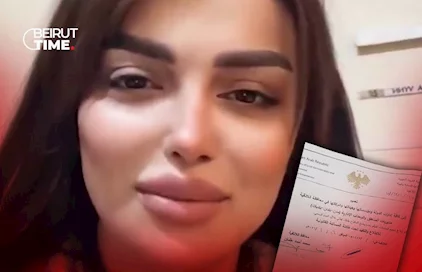مات رفعت الأسد.. عاشت «سلالة الدم»
مات رفعت الأسد.. عاشت «سلالة الدم»
ماذا يعني أن يموت أحد رموز القتل بلا محاسبة؟ ماذا يعني أن تتبدل الأنظمة، فيما تبقى أدوات القمع حاضرة بأشكال جديدة في سوريا؟
مات رفعت الأسد. هذا خبر سار، ومن غير المفترض أن يكون حدثاً عابراً في روزنامة الأخبار، بل لحظة كاشفة في تاريخ سوري طويل من الإفلات من العقاب. الرجل الذي خرج من الحياة بهدوء لافت، عاش فيها كأحد أكثر رموز السلطة السورية عنفاً وتجرّداً من أي إنسانية.
لم يكن مجرد شخصية ثانوية في نظام إستبدادي، بل أحد أعمدته الأكثر وضوحاً، وأكثرها إستعداداً لتحويل السياسة إلى جريمة مكتملة الأركان.
تزامن موته مع مفارقة لا يمكن تجاهلها، إبن أخيه بشار الأسد خسر الحكم، والنظام الذي صاغ رفعت وأمثاله تفكّك، فيما سوريا اليوم تحت حكم جديد برئاسة أحمد الشرع، مدعوم أميركياً وتركياً، يرفع خطاب القطيعة مع الماضي… لكنه يمارس، في الوقت نفسه، بعض أشكال العنف نفسها، وإن بأسلوب أقل وحشية. كأنّ سوريا تغيّر الوجوه، لا المنهج.
رفعت الأسد لم يكن «شقيق الرئيس» فحسب، بل كان التعبير الأكثر عرياً عن دولة قررت منذ وقت مبكر أن تحكم بالقوة الصافية. «سرايا الدفاع» التي قادها لم تكن مؤسسة عسكرية وطنية، بل ميليشيا عائلية مغلقة، وظيفتها حماية السلطة من المجتمع، لا حماية المجتمع من الأخطار. لم تُبنَ للدفاع عن الحدود، بل لتأديب الداخل، ولإيصال رسالة واحدة، وهي أنّ الدولة لا تُناقَش.
في الثمانينيات، بلغ هذا المنطق ذروته. لم تكن حماة حادثة طارئة ولا تجاوزاً في سياق معركة، بل تجسيداً كاملاً لعقيدة الحكم. هناك، لم يُقمع تمرد سياسي فحسب، بل جرى تدمير المدينة بوصفها فكرة إجتماعية وأخلاقية. القتل لم يكن نتيجة جانبية، بل سياسة معتمدة. والتدمير لم يكن خطأ في الحسابات، بل رسالة مقصودة، عنوانها أنّ الدولة حين تُسأل، تُجيب بالإبادة.
رفعت الأسد لم يكن مجرد منفذ لأوامر عليا، بل شريكاً في صناعة هذا المنطق. آمن أنّ الرعب ليس وسيلة مؤقتة، بل نظام حكم دائم. ومن هنا، لم يكن غريباً أن يُكافأ لاحقاً بالصمت. حين انتهى دوره داخل العائلة الحاكمة، لم يُحاسَب، بل أُبعِد. لم يخرج من سوريا إلى المحكمة، بل إلى المنافي الأوروبية الفاخرة، حيث عاش بين باريس ومدريد، محاطاً بثروات وقصور بُنيت فوق دماء لم يُسمح لها أن تتحوّل إلى ذاكرة عامة حتى.
اليوم، بعد سقوط حكم بشار الأسد، يسود وهم شائع بأنّ الصفحة طُويت. لكن السؤال الجوهري ليس من سقط، بل ما الذي سقط معه؟ الحكم الجديد برئاسة أحمد الشرع، رغم الدعم الأميركي والخطاب المختلف، لم يقطع جذرياً مع إرث العنف. ما زالت الدولة السورية تُدار بعقلية القوة، وإن تغيّرت المصطلحات. كأنّ المشكلة لم تكن يوماً في الأشخاص، بل في بنية ترى في القمع أداة إستقرار، لا جريمة تستدعي المحاسبة.
رفعت الأسد، حتى في موته، يذكّرنا بأنّ الجريمة في سوريا ليست فعلاً فردياً، بل سلالة سياسية متوارثة. له أبناء ورثة لهذا الإسم المثقل بالدم، في مقدّمهم ريبال الأسد، الذي حاول لاحقاً إعادة تدوير الإرث العائلي بخطاب ثقافي وسياسي ناعم، من دون أي قطيعة حقيقية مع الماضي. هنا، لا تكمن المشكلة في اللغة، بل في الجوهر. إسم صُنع بالدم لا يُغسَل بالبيانات ولا بالمؤتمرات.
ولرفعت الأسد إمتدادات خارج الجغرافيا السورية. في لبنان، كان له ممثل ومقرّب، الشيخ محمد الحاج حسن، المعروف بعدائه لحزب الله. مفارقة تختصر عبث المشهد الإقليمي. رموز خرجت من أنظمة قمعية، تتصارع فيما بينها لا على العدالة أو حقوق الضحايا، بل على النفوذ ومواقع الاصطفاف. العنف هنا لا يُدان، بل يُعاد توزيعه.
موت رفعت الأسد يفتح سؤالاً يتجاوز شخصه: ماذا يعني أن يموت أحد رموز القتل بلا محاسبة؟ ماذا يعني أن تتبدل الأنظمة، فيما تبقى أدوات القمع حاضرة بأشكال جديدة؟ في سوريا، لا يُقاس التغيير بسقوط الأسماء، بل بسقوط المنطق الذي جعل من رفعت الأسد ضرورة سياسية، لا خطأ تاريخياً.
رفعت لم يكن شذوذًا في النظام، بل أحد أكثر تجلّياته صدقاً. والمأساة الحقيقية ليست أنّه مات، بل أنّ شروط إنتاجه لم تمُت بعد. ما دام العنف مقبولاً باسم الدولة كما يجري هذه الأيام بحق الأكراد، وما دامت العدالة مؤجّلة، فإنّ «سلالة الدم» في سوريا ستبقى حيّة... مهما تغيّرت الأسماء والرايات والشعارات.