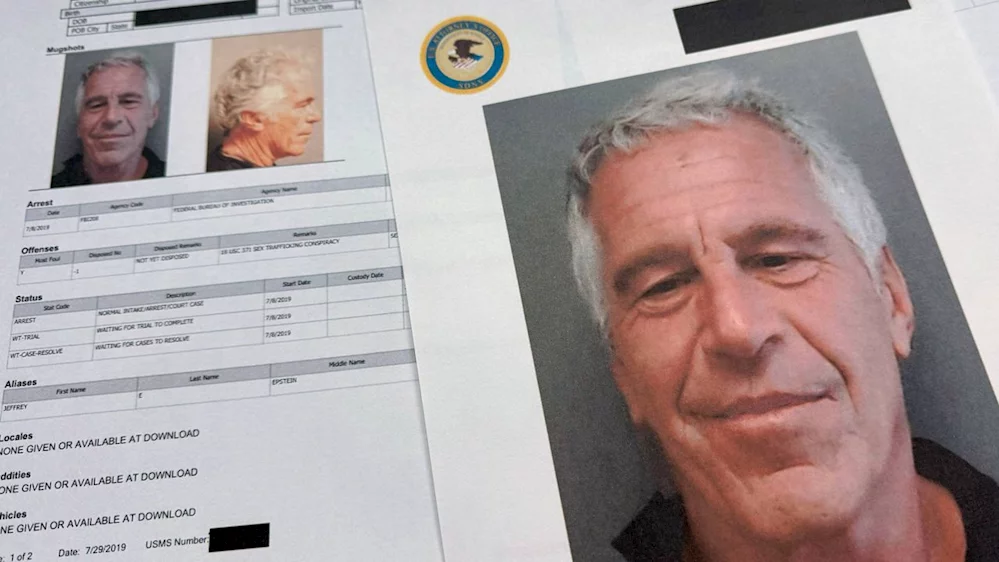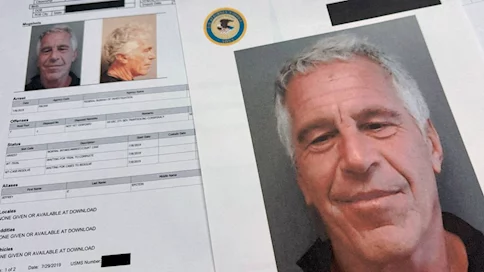الفضائح الكبرى تُدار لا تلاحق.. من إيبستين الى إنفجار مرفأ بيروت
الفضائح الكبرى تُدار لا تلاحق.. من إيبستين الى إنفجار مرفأ بيروت
العالم اليوم يُذكر بما قاله أغوسطينوس عن «محبّة الذات المتكبرة» في كتابه «مدينة الله»، مستلهماً الأحداث المأساوية لنهب روما سنة 410 م محذراً من الأخطار التي تهدد الحياة السياسية جرّاء التلاعب بالتاريخ وبمنظومة القيم، وتشويه نموذج رجل الدولة.
يجيب توم حرب اللبناني - الأميركي والسياسي الجمهوري في مقابلة ضمن برنامج «زمن بيروت» على منصة بيروت تايم مع رامي نصار عن مدى تورّط ترامب في ملفات إيبستين، مبرئًا إياه فيقول: «الفضيحة الجنسية والجرائم المرتكبة في هذا الإطار تفصيل في مقابل هذا العمل الإستخباراتي وأهدافه»، دون أية تفاصيل إضافية، ويؤكد أنّ «ترامب هو من سمح لكي تظهر هذه الملفات إلى العلن». كلام ملفت من شخصية مقربة من دوائر القرار، وهو مؤشر لا دليل.
فلم يعد السؤال مهماً من المتورط ولا الأسماء، ولا الصور والتفاصيل التي أغرقت وسائل الإعلام والمدونات والحسابات الشخصية عبر العالم. السؤال الجوهري: لماذا نعرف الآن؟ ولماذا لا نعرف الباقي؟ يبدو أنّ الفضائح لا تُدار لكشف الحقائق، بل لتحديد ما يسمح لك أن تغضب منه. يشير أيضًا توم حرب إلى أنّ ترامب «طرد إبستين من مقره في فلوريدا سنة ٢٠٠٢..» وأيضًا «أجبر محامٍ مقرّب منه على الاستقالة عندما عرف أنّه يدافع عن إبستين».
كل ما يُدار يبدو جزءًا من منظومة تفرغ الفضيحة من بعدها البنيوي المتجذّر في السلطة، وتركيزها على الشخص المنحرف، بدل الإشارة إلى أجهزة الحماية على مدى عقود، و«التواطؤ السياسي والاستخباراتي»، والشبكات العابرة للقارات. الكذب لم يعد استثناءً بل أداة تشغيل؛ فلم تُذكر الجريمة في أصولها ومنشئها، بل أغرقت في روايات متناقضة: انتحار، اغتيال، فشل أمني، مؤامرة، والنتيجة شلل أخلاقي؛ فالجمهور لا يعرف ماذا يصدق فينسحب.
أو يبقى في تشتت ذهني، يتفاعل مع الفضائح الجنسية كخليط من الفضول الفطري، وتعزيز المكانة الاجتماعية، و تفريغ الكبت، ورغبة في العقاب الأخلاقي كآلية دفاع جماعية بحسب علم النفس. وإلا كيف نقرأ هذا الكم الهائل من التعليقات والإسقاطات في الإعلام وعلى وسائل التواصل في العالم العربي على سبيل المثال لا الحصر، التي انبرت لإظهار الرفعة الأخلاقية للشرقيين مقابل «سقوط الغرب الأخلاقي» وكأنّه شرق خالٍ من الفضائح والقتل والإقصاء، ومجازر الأقليات وممارسات السبي واستغلال النساء..
والشبكات المرتبطة بإيبستين التي يقال عنها ذات أعمال إجرامية، كما هو واضح، لا تبدو مطاردة بل محمية؛ لا تُلاحق بل تُدار إذا كانت تخصّ النخبة السياسية والأمنية. الحماية لا تعني غياب القانون، فمثلًا الثنائي كلينتون وغيرهما من دائرة النخبة قد يمثلون أمام التحقيق، لكن قد تُعلق الملاحقة القضائية عند النقاط الحساسة، أي عند الاقتراب من البنية لا الأفراد.
ملايين الوثائق أُفرج عنها، والإعلام، وفق تحليل نعوم تشومسكي، يساهم في هذه الحماية من حيث لا يعلن. يُسمح بالكشف الجزئي، بالقصص الفردية، وبالفضائح الأخلاقية، لكن يُمنع الربط البنيوي. يُلاحق الشخص، لا الشبكة؛ يُدان السلوك، لا النظام الذي سمح به. هكذا تبدو الدولة في حالة محاسبة، بينما تبقى البنية آمنة.
تحذّر الفيلسوفة حنة آرندت من أخطر أشكال السلطة التي تجعل الحقيقة غير فعالة على المستوى السياسي. الصور منتشرة، والوقائع واضحة للعيان، والأسماء تتراكم دون نتائج مترتبة؛ وهكذا يبدو للإنسان العادي المتابع أنّ المعرفة بالوقائع أصبحت جزءًا من آلية السيطرة، الجميع يعرف، لكن لا يستطيع الفعل. لأن المطاردة إذا حدثت تعني تفكيك البنية القائمة التي تهدد التوازن، فإذا كان الخيار بين العدالة والاستقرار، يختار النظام الاستقرار.
بشاعة ملفات إبستين تكمن في ورود أسماء عمالقة التكنولوجيا الرقمية التي تصنع المزاج العالمي، تعيد صياغة منظومة القيم، تقرّر الخوارزميات ما المسموح وما الممنوع، إذاً، المتهم مساهم في نشر الفضيحة، يفندها. لكن البنية قائمة ومستقرة وتزداد سيطرة وتمددًا. في مواجهتها تحاول الدول استيعاب المخاطر الرقمية على ثقافتها الوطنية والأجيال المقبلة، وفي يقظة تشبه يقظة ما قبل الموت والمقصود هنا الموت الأخلاقي والروحي، تبادر الى حظر التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين.
في السياق اللبناني، يمكن رؤية أنماطاً مماثلة في إدارة الفضائح الكبرى .تمامًا كما تُدار فضيحة إبستين بطريقة تحمي البنية وتحصر الغضب عند الشخصيات الفردية، يمكن قراءة عدد من الملفات اللبنانية من منظور مشابه فالأحداث الكبرى تُغطّى إعلاميًا، لكن الأنماط البنيوية والشبكات السياسية، أجهزة الأمن، والارتباطات الاقتصادية تبقى بعيدة عن التفكيك.
فكثرة الروايات أثبتت أنّها لا تكشف الحقيقة، بل تعطّل مسارها السياسي. ففي انفجار مرفأ بيروت، لم تُنكر الكارثة ولا حجمها، وجرى تداول التفاصيل التقنية بكثافة، نترات الأمونيوم، الإهمال، المسؤوليات الإدارية. لكن مع الوقت، أُفرغ الحدث من بعده البنيوي: شبكة تقاسم السلطة، تداخل الأمن بالسياسة، وتعطيل القضاء. تحولت الجريمة من نتاج نظام إلى ملف قضائي معطّل.
حتى في حالات الإغتيال السياسي أو ملفات الفساد، يظهر النمط ذاته، نقاش واسع حول الحدث، تفاصيل لا حصر لها ثم تضييق متعمد على السؤال الأخطر: من يملك القرار؟ ومن يحمي المنظومة؟ هنا تعمل آلية الدولة العميقة، لا تمنع التسريب، بل تديره؛ لا تُغلق الفضيحة، بل تفرغها.
العالم اليوم يذكر بما قاله أغوسطينوس عن «محبّة الذات المتكبرة» في كتابه «مدينة الله»، مستلهماً الأحداث المأساوية لنهب روما سنة 410 م وأدى الى سقوطها بعد عقود قليلة، فحذر من الأخطار الجسيمة التي تهدد الحياة السياسية جرّاء التلاعب بالتاريخ وبمنظومة القيم، وتشويه نموذج رجل الدولة. على الرغم من اختلاف السياق الحالي عن القرن الخامس، فإنّ بعض أوجه الشبه لا تزال راهنة إلى حد بعيد. كما في ذلك الوقت، نحن الآن في زمن يشهد إعادة ترتيب عميقة للتوازنات الجيوسياسية والنماذج الثقافية، بحسب تعبير البابا فرنسيس: لسنا في عصر التغيير، بل في تغيّر العصر.