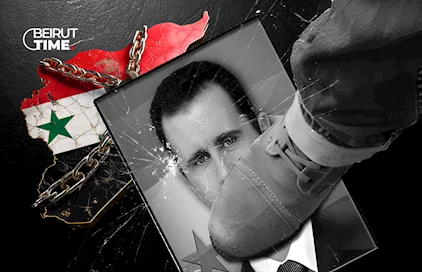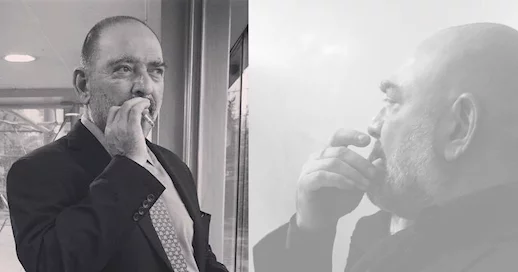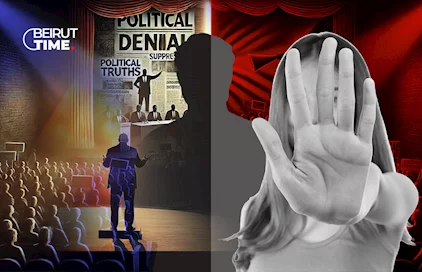غابت المصارف.. إنطلقت المشاريع الإنتاجية
غابت المصارف.. إنطلقت المشاريع الإنتاجية
غياب دور المصارف الطبيعي إنعكس إنتعاشاً في الاستثنارات، وكأن الانهيار كان ضروريَ ليعيد الاقتصاد برمجة نفسه، بالحد الأدنى.
في وضعٍ طبيعي، تقدّم المصارف خدمات مصرفية وقروض، إضافةً إلى التدفق النقدي وإدارة الخزانة، وقبول المدفوعات، وحلول التمكين التجاري مثل كشوف الرواتب والمحاسبة. وأحد أبرز أدوارها في الحركة الاقتصادية يكمن في تقديم قروض لأفراد أو شركات، وتتلقى بالمقابل مدفوعات الفائدة على تلك القروض. وتجني البنوك الأموال في المقام الأول من الفوائد على القروض والرسوم التي تفرضها على عملائها.
ويمثل عملاء الشركات الصغيرة، فرصة رئيسية للبنوك لتعزيز إيراداتها، ليصبح عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر أهمية، كمحرّك لجمع الودائع، حيث تتسابق البنوك للفوز بالودائع والإحتفاظ بها وسط منافسة شديدة. لكن في لبنان، ومع إنهيار النظام المصرفي، توقفت عمليات الإقراض، مما يفترض تراجع الإقتصاد، والإستثمار وخلق فرص عمل وتطوير القطاعات الإنتاجية.
عودٌ على بدء
عام 2015، قرّر ريمون حناينية، البالغ 37 عاماً، البدء بمشروعه الصغير، في تنظيم الأعراس وطاولات الشوكولا. واجه يومها صعوبات، أبرزها غياب رأسمال كافٍ، مما أجبره على بدء العمل من خلال عروض محدودة طوال عامين، ذهب كل ما يجنيه لتغطية تكاليف العمل. لم يكن القرض المصرفي خياراً ، كونه ليس موظفاً. بعد عامين، بدأ يتلمس نجاح مشروعه. ومع اندلاع الأزمة، واجهته مشاكل عدة، أجبرته على وقف عمله، من تراجع المردود، وارتفاع التكاليف، وعدم قدرة الناس على الدفع بالدولار، وهو ملزم بالتسعير بالعملة الأجنبية، حيث تجار الجملة يتعاملون بالدولار.
منذ عام، عاد لتفعيل عمله، وكانت الخطوة سهلة نسبياً، لتوفر جزء من أساسيات العمل، كما أنّ قرار الدولرة، أجبر التجار على الالتزام بهامش ربح، مما خفّض الأسعار، وعادت السيولة نسبياً إلى أيدي الناس، مما جعل هامش ربحه يعادل ما كان عليه قبل الأزمة.
والإيجابي اللافت، إنتشار المشاريع والأعمال الصغيرة في لبنان، إذ قبل الأزمة، كان الإهتمام بالأجمل والأغلى والمستورد، فيما ساهم الحجر الصحيّ والأزمة الاقتصادية إلى توجّه الناس نحو البيع على الانترنت. ويرى حنينية أنّ من إستطاع سحب أمواله من المصارف في بداية الأزمة، ومن كان يملك مبلغاً صغيراً، اتجه نحو الاعمال على الانترنت، وهذا الإستثمار ساعد الناس الحفاظ على أموالهم خارج المصارف وجني بعض الأرباح منها.
تحدّي الأزمة وجائحة كورونا
في ظلّ الأزمة،أراد محمد شوقي (27 عامًا) إعادة ترتيب خططه بشكل منسق. فقرّر الإستثمار في ملهى ليلي في منطقة الحمرا باستخدام المبلغ الذي حصل عليه من عائلته. واجه صعوبات بسبب إرتفاع سعر الصرف، وما نتج عنه من تقلبات الأسعار، وعلى وجه الخصوص الإيجارات. فقد كانت العقود لا تزال مرتبطة بسعر صرف 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما انتقل مالك العقار الذي يستأجره إلى فرض أسعار استنادًا إلى السوق السوداء للصرف. ومع ذلك، توصل المالك ومحمد إلى حل يرضي الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، واجه محمد مشاكل في التوظيف، حيث أنّه لم يكن قادرًا على زيادة الرواتب ليتمكن من التوظيف بما يتناسب مع الظروف المستجدة. كما أنّه لم يكن بإمكانه رفع الأسعار لتغطية تكاليف الرواتب.
أمّا فيما يتعلّق بالكهرباء، الفواتير تسدّد بالدولار، و التيار الكهربائي ليس متاحًا بشكل مستمر. فتأثرت ساعات العمل في الملهى بشكل خاص، حيث كان يجب على محمد الإمتثال للساعات المحدّدة للفتح والإغلاق، ولم يكن من الممكن تأخير ساعات الإغلاق بسبب القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، وقد تمّ تقليص سعة المحلات إلى النصف، أضف أنّ قطاع الكحول والترفيه كان آخر القطاعات التي سُمح لها بالعودة إلى العمل.
على الرغم من جميع هذه التحديات، اختار محمد شوقي مواصلة العمل لامتلاكه الخبرة في هذا المجال ، ولم يكن لديه حلاً بديلًا. و البقاء في المنزل ليس خيارًا ممكنًا، كما أنّ الوظائف الثابتة ليست الحل نظراً للرواتب المتدنية. لذا، كان عليه أن يبدأ عملًا مستقلاً لتحقيق بعض الدخل الضئيل..
لم يكن عدد الزبائن كبيراً، وكان يعمل لتغطية المصاريف، وليس لجني الأرباح. إلى أن أقفل المكان عام 2023، وقرّر بعدها تأسيس مشروع مقهى مجدداً.
واجه ظروفاً مختلفة، فالعلاقة مع الموردين باتت أسهل، والأسعار عادت كما السابق،.
لكنه يعتبر أنّه لو بدأ العمل قبل الأزمة لكان الوضع مشجعاً أكثر، وكانت نسبة الربح أعلى بكثير.
شريحة العملاء المستهدفين مختلفة حالياً، إذ سابقاً كان التوجّه الى الطبقة المتوسطة، الآن اختفت هذه الطبقة، وبات المستثمرون أمام فئتين، الأثرياء والفقراء.
ويحاول الجميع خرق البيئة الثرية، لأنّ زبائنها ثابتون ، لكن في الوقت عينه، يتطلب الأمر رأسمالاً كبيراً.
وفي حال توفرت القروض المصرفية لكان من السهل البدء بعمل أو مشروع، حيث لن يستثمر ماله كله، بل سيرتكز على القرض، ويستخدم المبلغ المدخر لتغطية التكاليف المستقبلية.
أما اليوم، وإن عادت المصارف لتقدّم خدمات القروض، لن يخطو هذه الخطوة لعدم ثقته بالقطاع ككل.
أفضل من لا شيء
في تشرين الثاني الماضي، إفتتح امين العريضي، إبن الـ 32 عاماً، مع شقيقه، متجراً لبيع الحلويات الأجنبية، وتوّزع راسمالهما بين مدخراتهما والإستدانة، وهذا ما يشبه إلى حدٍّ ما آلية عمل المصارف.
وقد واجها صعوبات كثيرة، من أسعار الماكينات وأسعار البضائع، والحاجة إلى رأسمال أكبر، تتطلب الأمر أربعة أشهر من التخطيط والتحضير لإنطلاق المشروع، وكان خيارهما البقاء في القرية لأنّ إمكانية التفاوض في القرى مع الناس أكثر مرونة وأقل كلفة تشغيلية، بالرغم من محدودية السوق وعدد الزبائن
بعد جائحة كورونا والأزمة الإقتصادية راجت السياحة الداخلية ومعها إزدهر سوق بيوت الضيافة والسياحة المحلية وغيرها، فازداد عدد قاصدي الأرياف ، أو الزبائن الجدد، لكن الإضطرابات الأمنية والحرب في الجنوب أثرت بشكلٍ سلبيّ على وتيرة العمل. والعريضي ككل المستثمرين الصغار يحاول الحفاظ على إستمرارية العمل بحدها الأدنى على أمل أن تتحسن الظروف.
الجشع الذي أكل المصارف
تخلي الناس عن المصارف، والتوجه نحو الإستثمار، خلق نمط إقتصادي أكثر إنتاجية. مع بداية أزمة ٢٠١٩ ، بلغ حجم الودائع في المصارف 250 مليار دولاراً، ما يفوق 4 مرات حجم الإقتصاد اللبناني. ومن بين 3 ملايين حساب، هناك 24 ألف تجاوزت قيمة الوديعة فيها المليون دولاراً، أي أقل من 1 في المئة من عدد الودائع، وشكلت مجتمعةً 85 مليار دولاراً، ويصنفون من أصحاب الثروات، الذين استفادوا من النموذج المصرفي، الذي ضاعف أموالهم من جراء تثبيت سعر الصرف بـ 1515، وبيع سندات الخزينة بفائدة وصلت إلى 43 في المئة، وتخفيض ضريبة الأرباح من 29 إلى 10 في المئة عام 1994، وإعفاء الربح العقاري من الضرائب. في المقابل بقيت الدولة على سياسات الإستدانة، حتى بات جزءاً من إنفاقها لتسديد خدمة الدين العام.
وفي غياب خطط للإستثمار وتطوير القطاعات المنتجة، وتعزيز القطاع العقاري، والتشجيع على التوظيف بسندات الليرة، تراكمت الودائع والربح من الفائدة، وشُجِع الإستهلاك عبر القروض في كلّ المجالات، من السكن والتعليم والسفر وعمليات التجميل والسيارات وغيرها، وتمّ ضرب الإنتاج المحلي، وبات الإستيراد هو القاعدة. وهذا ما ولّد مجموعة من التجار والمحتكرين، مما خلق عجزاً تجارياً بقيمة 17 مليار دولاراً. وبتنا أمام إقتصاد «زومبي»، ومصارف تراكم أرباح على حساب المجتمع ومستقبله، حتى بات اليوم الإقتصاد النقدي هو الرابح، والأكثر إنتاجية.